سياسة الاغتيالات الإسرائيلية- تزايد الضحايا المدنيين وتغيير قوانين الحرب.
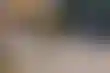
ربما يجهل الكثيرون حقيقة راسخة وهي أن إسرائيل انتهجت سياسة الاغتيالات الممنهجة منذ نشأتها، إلا أن موسوعة ويكيبيديا تحتفظ بصفحة موثقة تحت عنوان "قائمة الاغتيالات الإسرائيلية"، تسجل وقائع هذه العمليات. تبدأ هذه القائمة في شهر يوليو/تموز من عام 1956، وتمتد لتغطي فترة زمنية طويلة تصل إلى 68 عامًا حتى يومنا هذا. الغالبية العظمى من المدرجين في هذه القائمة هم من الفلسطينيين، بمن فيهم قادة فلسطينيون بارزون تركوا بصمات واضحة في تاريخ القضية الفلسطينية، مثل غسان كنفاني، الأديب والمفكر البارز من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ والقائد الرمز خليل إبراهيم الوزير، المعروف بـ "أبو جهاد"، وهو أحد أبرز قادة حركة فتح؛ والشيخ أحمد ياسين، المؤسس والزعيم الروحي لحركة حماس، والدكتور فتحي الشقاقي، مؤسس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
عند إمعان النظر في هذه القائمة المطولة، يتبين للمرء بوضوح أن وتيرة الاغتيالات والمحاولات التي قامت بها إسرائيل على مر السنين قد تصاعدت بشكل ملحوظ. فبعد أن كانت 14 محاولة في سبعينيات القرن الماضي، قفز الرقم إلى أكثر من 150 محاولة في العقد الأول من الألفية الجديدة، ووصل إلى 24 محاولة منذ شهر يناير/كانون الثاني من عام 2020 حتى الآن.
القتل لإرضاء الناخبين
استحضرت هذه القائمة إلى ذهني عندما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد مؤتمر صحفي في الثالث عشر من شهر يوليو/تموز الماضي، للاحتفاء بمحاولة إسرائيل الفاشلة لاغتيال القائد العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، في قطاع غزة. وكانت الطائرات المقاتلة والمسيرات الإسرائيلية قد شنت قبل ذلك بوقت قصير غارات جوية مكثفة على مخيم المواصي، الذي يؤوي حاليًا ما يقدر بنحو 80 ألف نازح فلسطيني يعيشون في خيام مكتظة وظروف إنسانية قاسية.
في غضون دقائق معدودة من إطلاق وابل الصواريخ والقذائف، ارتكب الطيارون الإسرائيليون مجزرة بشعة أودت بحياة ما لا يقل عن 90 فلسطينيًا، من بينهم العشرات من النساء والأطفال الأبرياء، بينما أصيب أكثر من 300 شخص آخرين بجروح خطيرة. وقد وقعت هذه الجريمة المروعة في منطقة سبق أن صنفتها إسرائيل نفسها على أنها "منطقة آمنة"، ومع انتشار الصور المروعة للجثث المتفحمة والممزقة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت تقارير مؤكدة تفيد بأن إسرائيل استخدمت في هذه العملية عدة قنابل موجهة أمريكية الصنع، تزن الواحدة منها نصف طن.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب بعد ساعات قليلة من وقوع المذبحة، اعترف بأنه "ليس متأكدًا تمامًا" من مقتل محمد الضيف، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "مجرد محاولة اغتيال قادة حماس تبعث برسالة واضحة إلى العالم مفادها أن أيام حماس أصبحت معدودة".
لكن حتى نظرة خاطفة على "قائمة الاغتيالات الإسرائيلية" تكشف أن نتنياهو كان يناور ويتحدث بكلام معسول هدفه التضليل. فهو يعلم تمام العلم أن اغتيال إسرائيل للزعيمين السياسيين لحركة حماس، الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، أو القائدين العسكريين البارزين يحيى عياش وصلاح شحادة، لم يكن له تأثير يُذكر على قوة الحركة أو تماسكها، بل ربما أدى إلى زيادة عدد المتعاطفين والمؤيدين لها.
وإذا كان هناك من عبرة يمكن استخلاصها من عمليات الاغتيال المتواصلة التي استمرت لسنوات طويلة، فهي أن القادة الإسرائيليين يستخدمون هذه العمليات في المقام الأول لكسب ود الناخبين واستمالة الجماهير، ولم يكن المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده نتنياهو استثناءً من هذه القاعدة.
وعلى الرغم من فظاعة ما تتضمنه قائمة ويكيبيديا من معلومات، فإن الأسماء الواردة فيها لا تحكي سوى جزءًا من الحقيقة، لأنها لا تتضمن عدد المدنيين الأبرياء الذين قتلوا خلال كل محاولة اغتيال، سواء كانت ناجحة أو فاشلة.
وعلى سبيل المثال، كانت ضربة الثالث عشر من يوليو/تموز هي المحاولة الثامنة المعروفة لاغتيال محمد الضيف، ومن الصعب حصر العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلتهم إسرائيل في سعيها الدؤوب لاغتياله. وتغفل قائمة ويكيبيديا عن توضيح كيف أدت الزيادة المطردة في عمليات الاغتيال إلى ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين.
سياسة الاغتيالات
يتجلى ذلك بوضوح عندما نقارن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية الحالية بسياستها خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية. فعندما اغتالت إسرائيل القائد البارز في كتائب القسام التابعة لحماس، صلاح شحادة، في عام 2002، أدى ذلك إلى مقتل 15 شخصًا، من بينهم شحادة نفسه وزوجته وابنته البالغة من العمر 15 عامًا، بالإضافة إلى ثمانية أطفال آخرين.
وعقب هذه الغارة، ثارت ضجة إعلامية وشعبية واسعة في إسرائيل بسبب الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين، ووصل الأمر إلى حد توقيع 27 طيارًا إسرائيليًا على رسالة يعلنون فيها رفضهم القيام بطلعات جوية لاغتيال المدنيين في قطاع غزة. وبعد مرور ما يقرب من عقد من الزمان، خلصت لجنة تحقيق إسرائيلية إلى أنه بسبب "الفشل في جمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة"، لم يكن القادة العسكريون على علم بوجود مدنيين في المباني المجاورة في ذلك الوقت، ولو علموا بوجودهم لألغوا الهجوم.
وتتماشى النتائج التي توصلت إليها اللجنة مع قوانين النزاع المسلح، التي تسمح، أو على الأقل تتغاضى، عن قتل المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، شريطة ألا تكون عمليات القتل هذه "مفرطة" مقارنة بالعمليات العسكرية "الملموسة والمباشرة"، وما يتوقع الطرف المتحارب الحصول عليه من الهجوم.
وتهدف هذه القاعدة، المعروفة بمبدأ التناسب، إلى ضمان أن الأهداف العسكرية للعملية تبرر الوسيلة المستخدمة، وذلك من خلال الموازنة الدقيقة بين الميزة العسكرية المتوقعة والأضرار التي قد تلحق بالمدنيين.
لكننا اليوم بعيدون كل البعد عن استنتاجات اللجنة فيما يتعلق بمستويات العنف التي تبنتها إسرائيل والمبررات القانونية التي تقدمها في الوقت الحالي.
فأولًا، تغيرت أساليب شن الحرب في إسرائيل بشكل كبير منذ عام 2002. ووفقًا لمنظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية، التي تتألف من قدامى المحاربين العسكريين، فقد انتهجت إسرائيل في هجماتها على غزة منذ عام 2008 مبدأين أساسيين: الأول هو عقيدة "لا إصابات" التي تنص على أنه من أجل حماية الجنود الإسرائيليين، يمكن قتل المدنيين الفلسطينيين دون خشية العقاب؛ أما المبدأ الثاني فيوصي بمهاجمة المواقع المدنية عمدًا بهدف ردع حركة حماس.
وليس من المستغرب أن تؤدي هاتان العقيدتان إلى هجمات ينتج عنها إصابات جماعية، وهو ما يشكل، وفقًا لقوانين الصراع المسلح، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ونتيجة لذلك، اضطر القضاة العسكريون الإسرائيليون إلى تعديل الطريقة التي يفسرون بها قوانين النزاع المسلح بحيث تتماشى مع استراتيجيات الحرب الجديدة.
وإذا كان قتل 14 مدنيًا قبل عقدين من الزمن عند اغتيال أحد قادة حماس يعتبر أمرًا غير متناسب وجريمة حرب من وجهة نظر لجنة التحقيق الإسرائيلية، ففي الأسابيع الأولى التي أعقبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقر الجيش الإسرائيلي بأنه يجوز قتل كل ناشط صغير في حماس حتى لو أدى ذلك إلى مقتل 15 أو 20 مدنيًا. وإذا كان الهدف هو مسؤول كبير في حماس، فإن الجيش "يأذن بقتل أكثر من 100 مدني مقابل اغتيال قائد واحد".
إطلاق يد الجيش
قد يبدو هذا الأمر صادمًا، لكن ضابطًا في قسم القانون الدولي بالجيش الإسرائيلي كان صريحًا جدًا بشأن مثل هذه التغييرات في مقابلة أجراها عام 2009 مع صحيفة هآرتس، حيث قال: "هدفنا العسكري ليس تقييد الجيش، بل تزويده بالأدوات اللازمة كي ينتصر بطريقة قانونية".
كما صرح الرئيس السابق لهذه الإدارة القانونية، العقيد دانييل رايزنر، علنًا بأن هذه الإستراتيجية تم اتباعها من خلال "مراجعة القانون الدولي".
وقال: "إذا قمت بشيء لفترة طويلة بما فيه الكفاية، فإن العالم سوف يقبله. فالقانون الدولي برمته يعتمد الآن على فكرة مفادها أن الفعل المحظور اليوم يصبح مسموحًا به إذا تم تنفيذه من قبل عدد كافٍ من البلدان".
وبمعنى آخر، فإن الطريقة التي نحسب بها التناسب لا يتم تحديدها من خلال بعض المراسيم الأخلاقية المسبقة، بل من خلال القواعد والأعراف التي تعتمدها الجيوش عندما تتبنى أشكالًا جديدة وأكثر فتكًا في أغلب الأحيان من شن الحرب.
ومرة أخرى، نتنياهو يدرك ذلك جيدًا، وقد ذكر أنه وافق شخصيًا على قصف المواصي بعد تلقي معلومات واضحة حول "الأضرار الجانبية" المحتملة ونوع الذخائر التي ستستخدم.
والأمر الواضح هو أنه بينما تدمر إسرائيل غزة وتقتل عشرات الآلاف من الأبرياء، فإنها تحاول أيضًا إعادة صياغة معايير شن الحرب، وإحداث تغيير جذري في تفسيرات قوانين الصراع المسلح.
وإذا نجح نتنياهو وحكومته في جعل النسخة الإسرائيلية من التناسب مقبولة بين الدول الأخرى، فإن قوانين الصراع المسلح سوف تنتهي في نهاية المطاف إلى تبرير عنف الإبادة الجماعية بدلًا من منعه، والواقع أن هيكل النظام القانوني الدولي بأكمله أصبح الآن موضع شك وريبة.
